اللغة هوية وذاكرة ووسيلة مقاومة رغم ما تعانيه في زمن العولمة
يحل هذا العام “اليوم العالمي للغة العربية” الذي تحتفل به منظمة اليونيسكو، عربياً وعالمياً، في الـ18 من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة، في حال من الاضطراب الشامل الناجم عن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة وفلسطين، وما تحمله من نتائج خطرة قد تطال الواقع الجيوساسي والبشري، وتنعكس على مستقبل فلسطين نفسها.
اللغة العربية التي تحتفل بها هذا اليوم عواصم ومدن عربية وعالمية، هي “بيت” الإنسان العربي والجماعة، مثلما هي الذات والهوية، الوعي واللاوعي، ولا يمكن هذه اللغة أن تنفصل عن الحياة نفسها لأنها لغة الحياة، ولا عن الواقع أيضاً، لأنها ركيزة هذا الواقع العام.
يحل إذا هذا اليوم العالمي في مرحلة من القلق والخوف والانتظار، لعلها من أقسى المراحل المأسوية التي تشهدها فلسطين والعالم العربي، بل أصعب المراحل الإشكالية والمعقدة، في ما تحمل من أخطار سياسية وجغرافية وبشرية.
لغة عالمية
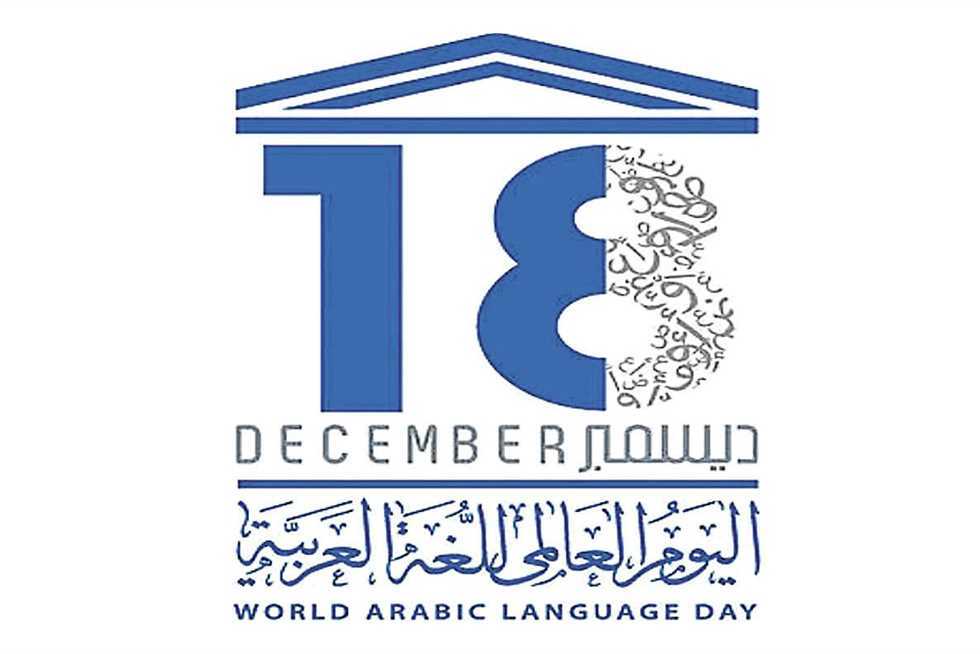
كانت اللغة العربية تنتظر هذا اليوم العالمي كي تخرج من حصارها الأهلي وتطل على العالم من خارج الأجندة الاستعرابية والسياسية… يوم عالمي للغة هي من أعرق اللغات التي ما برحت تتوقد حياة ما دامت لغة الملايين من العرب والمسلمين الذين يقبلون عليها ويصلون بها ويكتبون ويقرؤون .هذا اليوم الذي أعلن عالمياً، مثل الفرصة السانحة ليعاود العرب النظر في واقعهم اللغوي ويتصدوا للأزمة التي تعانيها لغة الضاد، لا سيما في زمن الانفتاح الثقافي والغزو اللغوي، سواء من خلال وسائل التواصل العالمي أم عبر القنوات الفضائية… ولئن بدا واضحاً قبل أعوام اهتمام المراكز والمؤسسات الثقافية العربية بهذه اللغة التي تحتل حيزاً واسعاً بين لغات شعوب الأرض، فما أنجز حتى الآن لم يؤت ثماره المنتظرة. ندوات ولقاءات ومؤتمرات لا تحصى تنتهي عادة بتوصيات ترفع ثم توضع في الأدراج. وإن لم تخل هذه التوصيات والبيانات من أفكار مهمة واقتراحات و”حلول” إزاء معاناة اللغة العربية، فهي في الغالب تميل إلى التنظير، ونادراً ما تدخل حيز المبادرة الحية والعملية.
درجت غالبية اللقاءات والندوات التي دارت حول اللغة العربية على مديح هذه اللغة بصفتها هوية الأمة وذاكرتها الحضارية ورمز خلودها، وسواها من المقولات التي باتت جاهزة ومستهلكة. هذا المديح لا بد منه دوماً، وقد سمعه المواطنون العرب حتى في “قمم” منظمة الدول العربية المتوالية، لكن مثل هذا الكلام لا أثر له في مجرى ما يحصل ويتفاقم في عقر اللغة العربية. فالأزمة في محل، والمديح في محل آخر. والشعارات تظل شعارات مهما كبرت وعظمت، وفي كل اللقاءات والندوات التي أقيمت في شأن العربية، كانت تحضر بشدة مجامع اللغة العربية، التي نصبت نفسها حارسة للغة الضاد وقيمة عليها ومولجة “تدبير” شؤونها .هذه المجامع تحديداً، هي التي تحتاج إلى حركة تحديث وتطوير وعصرنة، بعدما هجعت في أقبية التقليد والمحافظة والأصالة. ولعل أول خطوة توصف بـ”العملية” تتمثل في معاودة النظر في هذه المجامع التقليدية، وكذلك في بنيتها الثقافية ومناهجها ونظرياتها. لماذا لا تصبح هذه “المجامع” العربية بمثابة أكاديميات كما حصل في الغرب، تنفتح على الحداثة والعصر وتفتح أبوابها أمام اللغويين الجدد المطلعين على الثورات اللغوية الحديثة التي شهدها العالم؟ هذه المجامع هي القادرة حقاً، إن هي حدثت نفسها، على صيانة اللغة والحفاظ عليها وتصفيتها من الشوائب الدخيلة وحمايتها من “الغزو” الأجنبي، بذكاء وطواعية.
تطوير المجامع

والبادرة الأولى التي يجب أن تقوم بها هذه المجامع هي تطوير قواعد اللغة العربية وتبسيطها، صرفاً ونحواً، كي تقربها من الأجيال الجديدة وتصالحها بها وتحول دون نفورها منها .يعيش “المجمعيون” في ما يشبه البرج العاجي، متجاهلين ما تعانيه اللغة العربية في أوساط الشباب، وحيال الزحف اللغوي الأجنبي وصعود ثقافة الإنترنت. إنها الخطوة الأولى التي ينبغي أن تقوم المجامع بها، بغية تحديث القواعد العربية وجعلها ابنة العصر وسليلة الثورات اللغوية التي تهيمن الآن على وسائل التواصل والاتصال. أصبحت القواعد التقليدية عبئاً على التلامذة كما على الأساتذة أنفسهم، أصبحت أيضاً عبئاً على الكتاب والصحافيين. الأخطاء اللغوية تملأ صحفنا وكتبنا وواجهات إعلاناتنا. والأغرب أن تصل الأخطاء إلى بيانات المؤتمرات التي تعنى باللغة. وكم من كاتب بات يتمنى أن يكتب بالعامية ليتخلص من أسر القواعد العربية. أما الذين يؤثرون اللغات الأجنبية على العربية، فهم لا يحصون، وفي معظم الدول العربية.
من الواضح جداً ان الاستخدام اليومي للغة العربية يزداد سوءاً يوماً تلو يوم، ولا يبدو أن في الأفق حلاً لهذه المشكلة المستعصية. فقدت اللغة رهبتها وباتت عرضة للانتهاك المفضوح في معظم المرافق العامة، في الإذاعة، كما على الشاشات الصغيرة، في رحلات السفر، كما على الهاتف، في الندوات والمؤتمرات.
هذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها لغوياً فقط .قد يحق للمرء أن يخطئ في اللغة مثلما يخطئ في أي أمر. هذا على المستوى الفردي أو الشخصي، أما أن يعمم الخطأ ويصبح رائجاً مثل أية شائعة، فهذا ما لا يمكن الإغضاء عنه . وهنا يجب الفصل بين ما يسمي خطأ شائعاً وخطأً لغوياً، فالخطأ الشائع يظل على هامش القاعدة، ولو شذ عنها، أما الخطأ اللغوي فهو خطأ في قلب اللغة وقواعدها.
للغة العربية الراهنة ليست لغة الماضي. لقد شهدت لغتنا حالاً من التحديث الطبيعي بعيداً من أي افتعال أو تحدٍّ. لغة الصحافة العربية اليوم ليست البتة لغة العصور القديمة، ولا حتى لغة عصر النهضة. واللغة الأدبية، في الرواية كما في الشعر والنقد، ليست لغة العصر العباسي ولا لغة المقامات… لقد تطورت اللغة، وباتت مرآة العصر ودخلت إليها مفردات حديثة وأسقطت منها مفردات فات زمنها، عطفاً على المترادفات التي ظلت وقفاً على المعاجم. ما من أحد يستخدم اليوم كلمة الفدوكس أو الرئبال ليسمي الأسد، والأمثلة في هذا القبيل كثيرة جداً.
لا تتطلب إذاً معرفة القواعد الأولى أو البديهية إلى كثير من الجهد. يكفي أن يقرر القارئ المضي في إجادة لغته الأم، وأن يمضي بجد في هذا الأمر، حتى يكتسبها ويتحاشى الوقوع في الأخطاء، لكن هذا القارئ الذي يظن أن اللغة العربية أصبحت في وادٍ آخر، كما يقال، يؤثر العامية التي يتكلمها كل يوم، ويفضل ألا يبذل جهداً في سبيل لغة أضحت، في نظره، لغة الكتب. وهذا خطأ فادح، فالتراجع في استخدام اللغة ليس تراجعاً لغوياً فقط، بل هو تراجع في الثقافة، والتراجع الثقافي يدل على أزمة في الهوية والذاكرة والوجدان العام.
ترى هل من حل لهذه المشكلة المتفاقمة؟ ليس في الأفق مما يدل على أي حل، ما دامت الأخطاء تنتهب لغتنا العربية اليومية، وما دام القائمون على هذه القضية، على اختلاف مشاربهم، غير مبالين، مثلهم مثل الذين يرتكبون الأخطاء. تحديث القواعد، الصرف والنحو، هو حلم طبعاً. لا أحد يجرؤ على المبادرة بمثل هذا المشروع الذي وحده قادر على صيانة اللغة العربية وحمايتها والنهوض بها، وهذا ما حصل في كل اللغات الحية في العالم، فاللغة هي الحياة والإنسان، ولا يمكنها أن تظل أسيرة التقليد والانغلاق.
اليوم العالمي للغة العربية يحل في عام الأسئلة الشائكة

