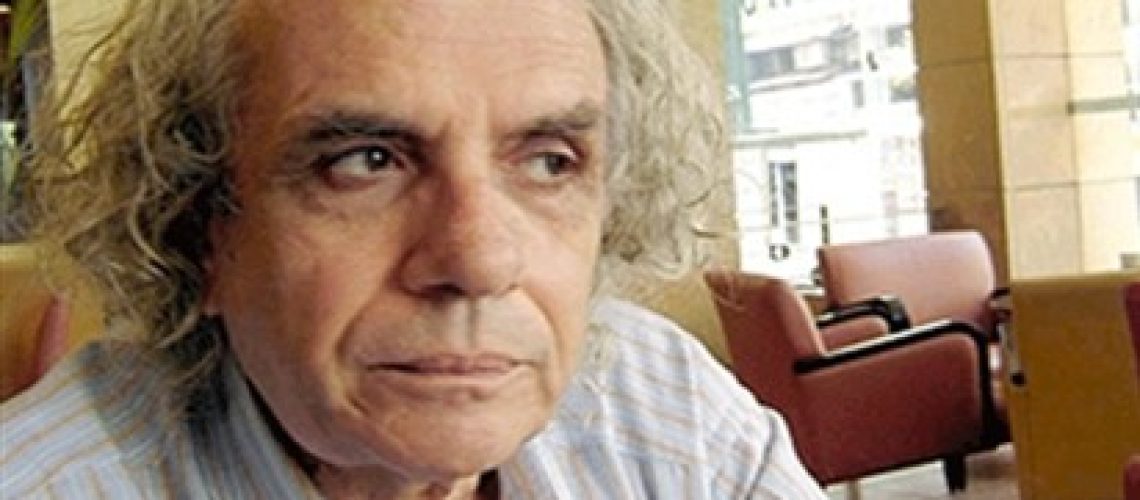علاقتي بالتكنولوجيا، منذ صغري، ملتبسة، وحتى عسيرة، ولا يمكن اكتشاف ذلك إلاّ بالممارسات العملية للأشياء والأمور التي تحيط بك. فعندما كان يهديني والدي لعبة في طفولتي بمناسبة العيد، معقّدة، أو تحتاج إلى تركيب عناصرها، أحاول عادة المحاولة، ثمّ أرميها: معقّدة. تحتاج ربما إلى ذكاء عملي (فطري).
كنت أفضّل أن أتعلّم صنع «طائرة ورق». صنعت منها، وأجدت. لأنها واضحة، ثمّ ومع السنين، تأكد ذلك: إذا أفلت شريط الراديو، أحاول معالجته، وبدلاً من إصلاحه أُفسد الراديو كلّه. وإذا احترقت لمبة أحاول تركيب أخرى، فأكسر الاثنتين. وإذا حدث تشويش في صورة التلفزيون، أسعى بكل أريحيّة إلى إصلاح الصورة، فتختلط كل الصور والمحطات، فأضطر إلى الاستنجاد بوالدي ليصلح الأمر، وأذكر عندما اشتريت ساعتي الأولى، وتأخّرت فجأة العقارب ذات يوم، أردت إشغالها، فسحبتُ البرغي، لأدير العقارب، فخرج كلّه وضاع بين الأشياء…
اكتشفت عبر هذه التجارب، أنني ما كنت لأصلُح لا لمهنة الساعاتي، ولا الميكانيكي، ولا الكهربائي. فهي أمور أبعد ما تكون عن «ذكائي»، بل أبعد ما تكون عن اختصاصاتي. حتى عندما اشتريت سيّارة، وانثقبت إحدى عجلاتها، عليَّ أن أنتظر مَنْ يفكّ العَجَلَة ويركّب أخرى.
هذا كان شأني. وأتذكّر، أنني حاولت التدرّب لإجادة الضرب على الآلة الكاتبة (الدكتيلو)، لم أصمد أكثر من ساعتين: صوتها مزعج، وحجمها كبير. حتى أنني كنت أستغرب كيف يكتب روائيّون وشعراء أعمالهم بالآلة الكاتبة. شيء عويص ومزعج. آلة لا تعرف الصمت. حركة آليّة لا تتوقّف، ولا تتوقّف الأصابع فيها عن الضرب المتواصل. اكتشفت أن العمل الآلي، الذي يصبح عادةً ومهارةً، لا يؤانسني ولا يسلّيني، بل فتح هذا الأمر نوافذ كبرى للخوف. الخوف من الآلة (التكنولوجيا)، من الآلات التي تحوّل العاملين آلات. بل ألْينة الجسد. الأصابع. العقل. المشاعر. الوعي. بل صرت أفزع من رؤية بعض الإدارات الممكننة في المصانع، أو المحال، التي تنتج سلعاً متشابهة بسرعة فائقة.
لا شيء من هذا كلّه. وأظن أن شعوري هذا يعود إلى رعبي مما يشبه التغريب إذا ما انخرطتُ في مثل هذه الأعمال. إنه مبدأ الروبوتات الذي بدأ اليوم يغزو العالم، إلى درجة بدأ بعض العلماء، يمارسون إحلال الآلة محل الإنسان، بما سمّي «الذكاء الاصطناعي»! سواء بتصعيد القدرات الدماغية وتحويل الإنسان سوبرمان، أو بخلق «إنسان جديد»، يتحرك تحرّكاً آليّاً.
من هنا، تنامى فيَّ الخوف من كل اختراع تكنولوجي طاغٍ يستلب الإنسان، يُشيِّئه، أو يدفعه إلى سلوك روبوتي. إنه عصر التكنولوجيا.
وعندما اختُرع الهاتف الخليوي، قلنا إنه سلعة تكنولوجية يستطيع أن يتحكم بها الإنسان، لا أن تتحكّم به. عال! اشترينا واحداً. ولم يكن قد جاء عصر الفيس بوك، والتويتر وسواهما. إنه أداة تسهّل الأمور. تحملها في جيبك، وتيسّر أعمالك واتصالاتك. إنها «هاتف ذكي»، لابدّ أن تتعامل معه بذكاء. أي للضرورة والحاجة، في مهن الصحافة والمصارف والمؤسسات والتواصل.
لكن، عدنا إلى نقطة الصفر. فهذا «الهاتف» معقّد. يحتاج إلى تعلّم وتدريب. كيف تحفظ مقالاً أو نصّاً، كيف تتّصل. كيف تكتب نصّاً. كيف تُحسن تخزين الأسماء أو حذفها… كل ذلك بدّد من أحلامي. فأنا غير مؤهّل بكل بساطة للتعامل مع هذه الأداة التكنولوجية. فما كان منّي إلاّ أن احتفظت بالخلوي، وتعلّمت فقط الاتصال والرد. أما تسجيل رقم، أو كتابة رسالة أو صورة.. فتركتها للزمن، لكن التعقيد ازداد، ولم يعد الخلوي مجرّد هاتف، بل صار أداة كتابة، وتصويراً فوتوغرافياً وراديو، ليضاف الفيس بوك، والمراسلات الاجتماعية. لم يعد أداة فردية بل جماعية. وكيف تهمل الإيميل والكمبيوتر، والإنترنت. إنهما «فنّانِ» متجاوران، وأحياناً متكاملان. واكتملت الدائرة، صار الخلوي جزءاً من الجسد. وكذلك الإنترنت.
وهنا بالذات، ازداد خوفي، هذا الخوف من هذه الظواهر، إلى الصدود عنها نفسياً، وعدم تعلّمها تقنياً. لأنها باتت، كما تابعتها في الشوارع والمنازل والمقاهي والمؤسسات، أفيوناً جديداً، لا تقلّ خطورة عن المخدّرات. صارت سلوكاً أبعد من الحواس. تذكّرت الآلة الضاربة، تذكّرت المصانع والعمّال، كيف تبتلعهم هذه الآلات. بل كيف تطمس أحياناً كثيرة، ما في كائناتهم من اختلاف، أو فرادة: التكنولوجيا وأنا، كالتوتاليتارية وأنا. كالديكتاتورية وأنا! كالاستلاب وأنا. كالغيبوبة وأنا. قال بعض الفلاسفة إن «الإيديولوجيا أفيون الشعوب»، وهذا ما أقوله عن التكنولوجيا كم توظّف اليوم، في تماديها وفي استعبادها للناس، بحيث يصبحون خاضعين لجبروتها ومتشابهين، بلا اختلاف أو فردية!
صحيح، أنني أريد مدفوعاً بالحاجة والضرورة إلى استخدام هذا النوع من التكنولوجيا، لكن ما يخيفني، أن أنخرط في لعبتها، لأنني عرفت وشعرت أنها أقوى منّي، إذا استسلمت لها. وأظن أن ما أشاهده من فصول مضحكة أحياناً، وأخرى أسيفة، في خضوع بعض مستخدميها لديكتاتوريّتها: تحوّل الشارع إلى مسرح مونودرامي: الأطفال والرجال والنساء والشيب والشبّان، يحملون هذه الأداة، وكأنّها تحملهم: هذا يصرخ وهو يتكلم مع زوجته في المقهى. هذا سرب من أربعة فتيان: فتاتان وشابان، يجلسون في المقهى، يطلبون ما يطلبون، ثمّ يأخذ كل واحد تلفونه، ويتكلّم. الأربعة يتكلمون إلا مع بعضهم بعضاً. ثمّ يقفون ويرحلون، وعندها يبدأ التصوير: أو يصوّر الواحد نفسه، أو يصوّر لقطة جماعية، أو فردية… ثمّ يتفرّجون على صورهم: رائع! رائع!
إنها النرجسيّة. فبدلاً من أن تكون شبكات تواصل وتبادل، وانفتاح، تصبح لعبة نرجسية خطرة. عُزلة. وعندما ينفتح البعض على بعضهم، فتصبح عزلة جماعية، أو نرجسية جماعية: الأصدقاء في الفيسبوك… متشابهون. فكراً، ومزاجاً، وثقافة، ومذهبيّاً، وسياسيّاً!. وكل ذلك، ومن خلال التمادي في الاستخدام اليومي: أحياناً الانعزال: لا قراءة. لا حضور مسرح أو سينما. أو معارض… وهكذا يمكن القول اليوم (وبحسب إحصاءات) إنه كلما تطورت التكنولوجيا في مثل هذه الأدوات ازدادت الأمّية، وتكاثر الجهل. فهناك التلفزيون في البيت. ولكل فرد خليويه… في العائلة. كلٌّ يمضي وقته على ليلاه: انقطع الحوار. الألفة. صار كلّ واحد يشبه تليفونه. أو تلفزيونه. أو كمبيوتره…
وهذا الموقف ليس جديداً عليَّ. فعندما اشتغلت في «وكالة الصحافة الفرنسية»، في قبرص، أجروا للعاملين دورة تدريب على الإنترنت، لم أنجح ولم أفشل. لكن، كان عملي جحيماً يومياً: ثماني ساعات دوام أمام كمبيوتري، أترجم أخباراً. استنفذ الأمر عقلي، وذاكرتي، وحتى صحّتي. ولم أصمد إلاّ خمسة أشهر، قدّمت فيها استقالي، والتحقت بعمل آخر.
وأتذكّر أنني عندما بدأت أعمل في جريدة «المستقبل» نُظّمت دورات للمحررّين، للتعلّم على ممارسة الكمبيوتر، إلا أنا. رفضت. وتمسّكت بالورقة والقلم، حتى أغلقت الجريدة قبل عدّة أشهر.
صحيح أنّني، بطبيعتي متعثّر في التعامل مع الأدوات المعقّدة، لكن الصحيح، أنني لا أجرؤ على التماهي التام بهذه التكنولوجيا… بهذه المعادن الصلبة. بهذه المفاتيح الصمّاء. بهذه الوحوش المفترسة، لأنني لا أريد أن يستلبني شيء. بقيت وفيّاً للورقة وللكتابة والقلم… وصرت، كما يقول البعض، من «أهل الكهف». ربّما! لكن، إذا حدث وتعلّمت هذا التعامل مع هذه الأدوات، فسيكون ذلك جزئيّاً، ومجرّد وسيلة لا طريقة في الكتابة، ولا اندماجاً في لعبتها.
وبرغم كلّ ذلك، فإنني، لن أكتب لا الشعر، ولا النثر، ولا أي شيء خصوصي، لا على الخلوي… ولا على الإنترنت!
فالشعر يبقى في مكانه الخاص: الورقة!
جريدة الاتحاد