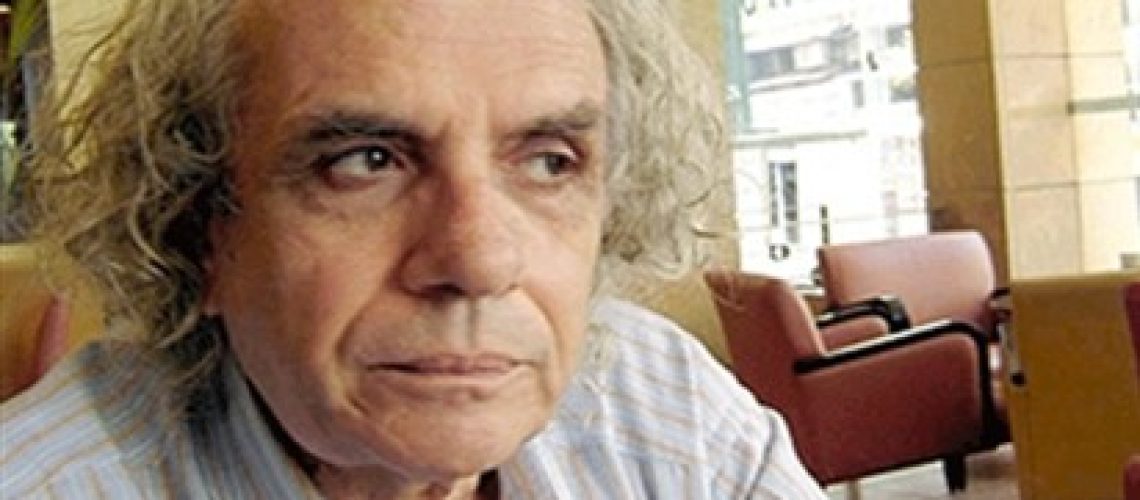بعد انتهاء المدارس الفلسفية والأدبية والفنية، وجلها تأسس في القرن العشرين (الكلاسيكية في المسرح في القرن السابع عشر في فرنسا، والرومانطيقية انطلقت من ألمانيا وإنجلترا ثم إلى فرنسا، والرمزية جمعت الاثنتين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر). أي أسئلة تطرح أو ما زالت تطرح؟ هل شكلت هذه المدارس عبئاً على الشعر وسواه؟ أم هي تفجر ما في كل عصر من اعتمالات وهواجس ورغبات وتجاوز؟ نقول ذلك لأن مجمل هذه المدارس تأثر بها العرب من خلال انفتاحهم على الغرب في عصر التنوير وعلى مختلف الفنون والتعابير. فهي وإن جاء بعضها إلى عالمنا العربي متأخراً نصف قرن أو أقل أو أكثر، فإنها في النهاية صنعت ما يمكن وصفه بالثقافة الجديدة، أو الحداثة، أو التغيير، أو حتى الثورة في الشكل وفي الرؤيا.
لكن ما معنى أن يتبنى الشاعر مثلاً بنود مدرسة ما سلفاً أي قبل الكتابة؟ ماذا يعني اعتناق طرق جاهزة في التعبير: أي طرق تسبق العملية الكتابية؟ كأن يختار مثلاً السريالية أو الدادائية ويلتزم شروطهما سواء انطلاقاً من بيانات تريستان تزارا (زعيم المدرسة الدادائية)، أو أندريه بريتون (زعيم المدرسة السريالية)، بحذافيرها، أو يلتزم في الرواية أفكار الرواية الفرنسية الجديدة (ميشال بوتور)، أو المسرح الكلاسيكي الأرسطي، أو المسرح المناقض للمخرج الروسي ستانسلافسكي، أو نظرية أنطونان ارطو (مسرح القسوة)، أو نظرة غروتوفسكي (المسرح الفقير)، أو عبثية ألبير كامو، بيكيت، ويونسكو؟ هل يجب أن يخضع الشعر لوصفة قد تكبّل طاقاته الكامنة وتقولبها ولما تزل سديماً أو احتمالاً في داخله أو في عقله أو أحواله؟ هل تتسع مدرسة واحدة لكل ما يعيشه شاعر أو روائي أو حتى فيلسوف، ولكل ما يمكن أن يبثه عصر ما من تحولات وتناقضات وأزمات؟
وهل كان علينا أن ننحرف إلى ما وراء هذه المدارس والتي تجمع من المؤمنين بها جماعات وطوائف؟
قرن الأيديولوجيات
هنا تتسع القضية إلى أسئلة جديدة لا تقتصر على الآداب والفنون فقط، بل تشمل الأيديولوجيات كلها من شيوعية ونازية ووجودية وبنيوية وتفكيكية وصولاً إلى الرأسمالية… والعصور الصناعية والتكنولوجية والتقدمية (كانت التقدمية مقدسة وحتمية عند أصحاب الفكر الصيروري، حركة التاريخ وحدها تحقق بحقائقها الثابتة الجنّة الأرضية وزوال الطبقات)، بل يطرح سؤال كبير للمناقشة: هل كان القرن العشرون إذاً قرن الأيديولوجيات والثورات العقلانية والمادية والتاريخية كما فهمها ماركس وإنجلز وتروتسكي ولينين وبرودون؟ هل صحيح أن كل هذه الأفكار الثورية هي فعلاً ثورات عقلانية أم أنها متأثرة تأثيراً كبيراً في خلفياتها العميقة بالدين والماورائيات، أي اختصاراً بالحتمية أو حتى بالقدرية والمرسوم سلفاً كما في الأديان السماوية؟
قال الكاتب الكبير أندريه مالرو في منتصف القرن الماضي إن القرن العشرين سيكون قرناً دينياً، لكن هذه الفكرة تفترض أن القرن العشرين لم يكن دينياً بل كما تصور الكثيرون أيديولوجياً مادياً.
ونرى هنا أن القرن العشرين في بعض مسالكه هو قرن الأيديولوجيات واليوتوبيات الغيبية المقنّعة وليس العكس، وإن القرن الحالي هو قرن الطوائف والمذاهب والتفكك. فالدين، كل دين، يتسم بالوحدة الداخلية والفكرية واللاهوتية والفقهية والماورائية، لكن ظاهرة الطوائف تضعف ما في الدين من حتمية بجعلها مفترضات سياسية هامشية وجزئية ووظيفية، لتخلق نماذج تخلط بين العصور والأفكار والأنماط والمسالك والطبائع والدلالات، والتأويلات المتصلة بالظروف الآنية، على غير انسجام مع التعاليم الدينية المتماسكة أو المنفتحة على التحولات والمقاصد والأطوار.
على هذا الأساس نجد أن مثل هذه العوالم وضروب الخروج على جوهر الفكرة الدينية بضوابطها، حلّت محل التأويل ومدارس اللاهوت والتفسير والفقه… إذاً الدخول في عتمة التشرذم لا التعددية، والتقوقع لا نظام الحماية، والخوف لا التمسك بالإيمان. أي محاولة إسقاط البنى اليوتوبية الدائمة المفتوحة على الاحتمالات. فالدين ليس احتمالاً بل حتمية. من هنا بالذات نعود إلى ما افتتحنا به مقالتنا.
سبل جاهزة
هل كانت المدارس الفلسفية والأدبية والفكرية والفنية تخبئ في لاأدرية مستغربة ما يمكن أن يجعلها على غرار الأيديولوجيات التاريخية تماثلات بما تحفظه الأديان أو حتى الطوائف الاجتماعية من سبل جاهزة؟
فلنبسط الأمور بأمثلة مختلفة:
فلنأخذ المدرسة السريالية التي وضع أحكامها ووصاياها أندريه بروتون في عدة بيانات مشهورة ذات بنود وإلزامات صارمة: على كل شاعر ينخرط فيها أو يعتنقها أن ينفّذ كل شروطها. البيانات واضحة حتى تماهيها بالمحلل والمحرم. بل حتى تماهيها بشروط التدين أي بشروط الإيمان (وعبارة الإيمان أصلاً من إرث ديني لا يخضع للمنطق الوضعي أو للتشكيك). بمعنى أن الشاعر يولد، إذا أراد أن يولد سريالياً. يطوبه أو «يعمّده» أندريه بروتون ويدخله إلى الصومعة.
ومن تابع أو يتابع مسار هذه المدرسة السريالية يعرف أن بروتون طرد عدة شعراء خالفوا وصايا بياناته المقدسة أمثال آرطو وآراغون والديار وجاك بريفير..
هنا بالذات يطرح سؤال الحرية عندما نجد أن برتون إما يلعب دور ستالين أو الرجل المقدس الذي يمتلك سلطة الحكم أو التحكم أو التحكيم؟ وليس غريباً أن يسمى بروتون «بابا السريالية» أو بطريركها أو زعيمها المطلق.
أكُل هذا جزء من الحداثة التي علّمتنا أنها قائمة على الحرية والتنوير وسلطة العقل والفردية وكسر الحواجز الشكلية والأفكار المسبقة؟ لكن الحداثة نفسها، وبعضهم يستخدم كلمة الحداثية ليقولبها في إطار أيديولوجي، ألم تكن جوانب منها أصولية؟ ألا يمكن القول إن الأصولية الحداثية مهدت إلى حد كبير للأصوليات الدينية والمذهبية والعرقية والاجتماعية؟ بل ألم تكن بعض تجليات حداثة التنوير سلالم يتسلقها الأصوليون الإثنيون والعنصريون والمتطرفون المضادون لجوهرها: ألم تطلع النازية من الحداثة الديمقراطية وكذلك الفاشية والصهيونية؟ ألا يجوز الكلام إن الحرب العالمية الأولى دمرت بأهوالها ما سمي «أسطورة التقدم والانفتاح؟»، حتى الثورة الفرنسية التي مهد لها كبار المفكرين والكتاب كفولتير وروسو ومونتسكيو.. ألم تقع في أصولية أيديولوجية جسّدها الطاغية الذي نصب المقاصل وقطع رؤوس المئات ممن كانوا في صلب الثورة وعلى رأسهم دانتون ومارا؟ إنها الأصوليات التي يعززها الإيمان المطلق بسلطتها وحقائقها. والستالينية نفسها ألم تكن جزءاً من الثورة الروسية الشعبية التي تحولت مع لينين إلى قيام أول دولة توتاليتارية في التاريخ؟
علماً بأن الشيوعية نفسها أبرزت ملامح كثيرة من أشكال الحتمية وحركة التاريخ الأحادية وزوال الطبقات ونهاية الدولة: إنها في رأينا يوتوبيا مسيحية تختصر بإدراك «الجنّة الأرضية» الموازية للجنة السماوية؟ نسوق كل ذلك لنشير إلى أن اليوتوبيات المادية والثورات على الأديان (ستالين دمّر مئات الكنائس) كانت في جوهرها امتثالاً لما ناقضته وإن بمنافذ واصطلاحات وأهداف مختلفة. ومن هنا نرى أن القرن العشرين هو قرن التوتاليتارية المتوالدة في الأيديولوجيا والأفكار والمدارس الأدبية والسياسية، ألم يعمد جادانوف باسم النظام الستاليني إلى تحديد قاموس الكتابات الأدبية عبر «الواقعية الاشتراكية» كمدرسة وحيدة للتعبير عن الشعب، ومن خلالها تم قمع الشعراء والكُتّاب الرومانسيين باعتبارهم انحطاطيين، خصوصاً الذين يعتمدون الأساليب الخاصة والفردية الغنائية. أوليس هذا رديف غوبلز وزير الدعاية النازية صاحب نظرية «اكذب اكذب تصبح الكذبة حقيقة» وذلك خدمة للنظام النازي، أوليس هذا ما نسميه اليوم الشعبوية؟
شموليات مقنّعة
إن التشابك بين هذه الظواهر التي طبعت القرن العشرين من شموليات مقنّعة أو سافرة عرفتها إلى حد كبير الاتجاهات والمدارس الشعرية والفنية. بل كان على كل كاتب أو فنان أو فيلسوف في بعض المراحل الديمقراطية أن يكوّن مدرسته الخاصة، وتالياً قبيلته، وثالثاً عزلته كما لو أنه يبني غيتو متأثراً ببعض التوجهات الإثنية أو الأيديولوجية أو الحزبية، بحيث يكون في حدود كل غيتو ثقافي مؤمنون بهذه المدرسة وزعيمها، بل راحت في المدارس الشعرية والفنية والأدبية تنافس نظيراتها السياسية: بيكاسو والتكعيبية، ميشال بوتور والرواية الفرنسية الجديدة، البنيوية وأصحابها كثر وأبرزهم فوكو، والتفكيكية وروادها، وقبلها الرمزية ورائدها مالارميه ورامبو، والوجودية وزعيمها سارتر، والنسوية مع سيمون دوبوفوار…
المدارس تتدافع لكن في ظننا أن هذه التوتاليتارية الجزئية طالعة من التوتاليتاريات الكبرى التي لم تعمر ولم تدم طويلاً لأنها عجزت عن ربط الحرية بأواصرها ومبادئها. فبيكاسو تجاوز التكعيبية إلى ما هو أوسع منها. وكذلك رينيه شار الذي خرج من السريالية وعانق حرية الكتابة، وحتى سارتر خان الوجودية عندما انضوى في الحزب الشيوعي الفرنسي ثم الماوية.
كان كل ذلك يمثل بشكل أو بآخر وجوه اليقين والإيمان للحقائق المطلقة في علاقة هذه المدارس التي تتناقض مع ضرورة تحولاتها بحرية غير مشروطة من كل إلزام أو أفكار مسبقة.
ونحن العرب عرفنا نهضة تنويرية إبداعية شابها هذا التماهي بالتسابق على من يجترح حداثته الخاصة ليتوّج رائداً: عرفنا رواد الرومانطيقية من إلياس أبو شبكة وجبران خليل جبران والأخطل الصغير والشابي وعلي محمود طه… والرمزية مع سعيد عقل ويوسف غصوب، والسريالية مع أنسي الحاج وشوقي أبو شقرا وسليم بركات… واندلعت معارك شرسة بين هذه الاتجاهات الحداثية وكأنها أحياناً تحمل ملامح الحروب الطائفية والدينية المرتكزة على الإيمان والالتزام المطلق كما يحصل عادة في الأحزاب.
من هنا يمكننا القول إن القرن العشرين هو قرن الأيديولوجيات المتوالدة، لكن ذات المنابع والخوافي الدينية.
جريدة الاتحاد